
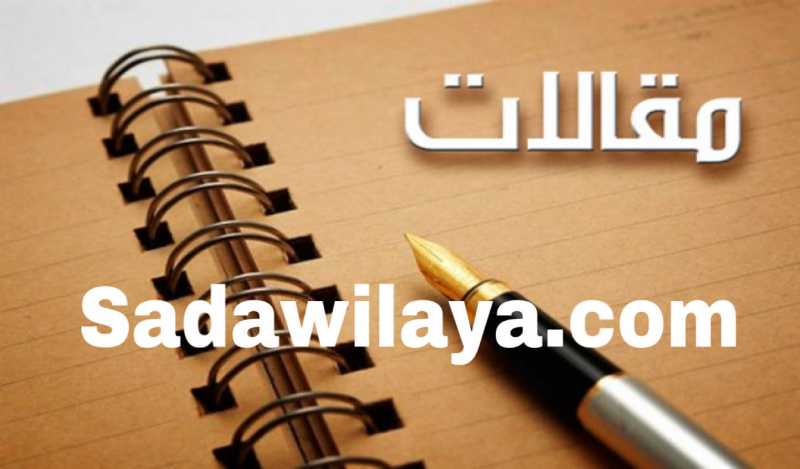
الدولة فكرةٌ وثقة وتطلّع، قبل أن تكون آليات ومؤسسات. هي ليست «أرضاً وشعباً ونظاماً سياسياً» فقط، هي صيرورة تاريخية وإدراكية وشعورية لمعنى الاجتماع ومشروعيته وعقلنته. هي معنى متقدّم وحقيقة يتلمّسها أبناؤها ويخلدون إليها، وعبرها يظنّون أنّهم سيولدون ولادة أكثر ترقياً في إنسانيتهم ومداها.
المؤسسات في الدولة يجب أن تعبّر عن طبيعة السلطة والحكم وهي إحدى ضرورات تطوير الدولة لنفسها، فتحقّق ضمانة الإصلاح والتكيّف مع التحوّلات بأفضل طريقة وبأقلّ كلفة.
عندما يُثار بحث أمور جوهرية تطال الكيان وهويته، من مثل الإستراتيجية الدفاعية، فإنّ هكذا أمور لا يمكن أن تبحث بعيداً من إستراتيجية وطنية شاملة أو رؤية أمن وطني كما عبّر خطاب القسم. ولا أظنّها تبحث بعيداً من لحظة مناسبة لأرضية متوازنة ومتعادلة ومتكافئة بين اللبنانيين. ولا تبحث في ظل هيمنة وسطوة غربية أميركية وإطباق تام على المؤسسات وقرارها وانتقاص حاد وسافر لسيادة لبنان.
في الحقيقة، لا يمكن أن يكون التفاوض إلا بين اللبنانيين وليس بين جزء منهم وبين وكلاء الأميركي في لبنان كما يستوحى مما يعيشه لبنان اليوم أو كما هو الواقع فعلاً. والغريب أنك أمام حكومات حالها كوسيط «نزيه» بين الأميركي وبين شعبها أو «محايد».
إن مقتضى البحث في حماية هوية لبنان وكينونته واستقلال قراره، مؤسسات قرار وطنية الانتماء، علمية المقاربات، أخلاقية البناء، غير مفروضة على اللبنانيين لا بالترغيب ولا بالتهديد ولا بالتدليس. ومقتضاه سلطة سياسية معبّرة عن الإرادة اللبنانية أولاً وابتداء وليست في غربة عنهم.
مقتضاه مشاركة متساوية ومتعادلة بين المكونات والأفراد بهدف ردم الهوّة الداخلية في التأثير في المؤسسات والتقرير من داخلها (كتجلٍّ للمساواة الداخلية المفقودة). ومقتضاه توازن لازم في العلاقات الخارجية للبنان، أي التوازن بين كل أصدقاء لبنان الفعليين والمفترضين وليس انحيازاً للدول الإمبراطورية على حساب الدول الحضارية، وللغرب دون الشرق.
وعليه، إن أولئك المستعجلين لبحث احتكار الدولة، يسارعون إلى أحد الجوانب دون غيره ويضيّعون الأَوْلى. فإذا كان احتكار القوة المادية على أرض الدولة أمر مطلوب، لكن كيف يكون في ظل وجود تهديد فعلي قائم من عدو وعجز لمواجهته من قبل السلطة. أبعد من ذلك: أنّا يكون في غياب سيادة، بل وفي معرض احتلال يمارسه العدو.
يمكن الحديث في احتكار السلاح في حال تحقق السيادة والحماية الموثوقة للبلد ومكوناته ورسالته بعد تحديد كل ذلك، لذلك نقول إنّ هناك زوايا أكثر احتياجاً يفترض فتحها وتقديم إجابة لها.
هل الدولة العتيدة تحتكر السيادة؟ هل تحتكر سلطان القرار الاقتصادي والسياسي والثقافي بل والاجتماعي؟ هل تحتكر تعريفها لذاتها؟ هل تحتكر تحديد مصالحها ودورها وماذا تريد وما هي التزاماتها وكيف توفيها؟ هل تحتكر اليوم سلطة التشريع وسلطة الانتخاب الديموقراطي الحرّ؟ هل تحتكر سلطة رأس المال والكارتيلات المختلفة؟
نذهب أبعد فنسأل: إذا لم تكن الدولة تحتكر ما ذكرنا، فهل السلطة في لبنان تسبق بسلطان المعرفة والعلم أو بمناقبية وفعالية أرشد من الانتماءات والدوائر الاجتماعية الأخرى؟
على ضوء ما تقدّم، إنّ تمفصل وعتبة دخول مرحلة الدولة الوطنية هي السيادة أولاً، وسلطان المعرفة والعلم، الذي يجب أن تتميّز به الدولة. ومعها، أي مع السيادة، وتحقّقها الفعلي، تبدأ الجماعات والأفراد بالانضواء، وتعطي لنفسها فرصة استكشاف المجتمع الجديد في ظل الدولة وما تعنيه من هندسة اجتماعية جديدة.
ومع المعرفة والعلم تنجذب الجماعات دوماً إلى الأعلم والأكثر كياسة لما يشكل لها من ملاذ وطمأنينة حتى قبل الحمايات المادية. السيادة تعني أنّ البيئة الوطنية أصبحت تتيح للأطراف الداخلية إمكانية ولوج التجربة بعيداً من تأثيرات الخارج وتدخّلاته التعديلية.
إنّ تدخّل الخارج الهيمني يطيح بفرص الحوار البنّاء ويخلّ التوازن الداخلي، كيف إذا كان هذا الخارج هو الأميركي الذي هو ظهير عدوّ لبنان -الكيان الصهيوني- وعدّو نصف اللبنانيين ومهدّد وجودهم وقيمهم وهويتهم. والمعرفة تعني أن هناك ملاذاً أرقى ننضوي في كنفه ويوسّع استعداداتنا.
لبناء الدولة نحتاج أن نفهم الدولة أولاً؛ فالدولة نقطة تحوّل وترقٍّ حضاري وليست شركة وتعاقداً إدارياً بين متعاقدين، وإلّا ينفضّ المشاركون عند أوّل انتكاسة أو تحدّ ويرموا بأنفسهم من قاربها. الدولة تبدأ من الداخل فتستجمع عناصر قوّته وتستفيد من تلاوينه وتنوّعه ثم تنتقل إلى الخارج، وليس الخارج من يحدّد لها ما تريد. الدور والمكانة لا يوهبان، وكذلك الاعتراف، بل ينتزعان.
الدولة مفهوم غير ناضج بما فيه الكفاية في عالمنا العربي، وفي لبنان كما يبدو. نريد أن نبني دولة ونحن ننبهر بالتقليد بدل الصناعة، ونستسهل الإسقاط بدل نحت تجربة تُشبهنا. نقارب بسطحية بينما الدول تحتاج إلى مقاربات عميقة وجادّة ومسؤولة ولا تبنى بالغنج والطفولية! نظّن أنّ المال والمادة كلّ شيء بينما أقصى ما يمكن أن تبنيه المادة هو شركة وقد تبني مؤسسة لكنها لا تبني دولة.
الدولة، في بعض وجوهها، كالكائن الحي؛ إذا لم تتفاعل فكرتها أو لم تكن حركة موجبة ولديها رسالة تنحسر وتصبح في موقع المتلقّي وتتغيّر هويتها ثم تموت. الدولة الحضارية تشبهنا أكثر لأنها تقوم على الثقافة والقيم قبل المادة، بينما دول الهيمنة تقوم على أولوية المادة والتشييء، وإلا نكون إزاء ارتداد حضاري كالكيان الصهيوني والنظام الأميركي اليوم.
ها نحن بعد قرن -وقبل حزب الله وولادته- لم ننتج دولةً بل ترانا أنتجنا أرخبيلاً. فمن هيمن على الدولة لعقود أوصلها في نهاية الطريق إلى الحرب الأهلية وكان لديه من الجرأة والقسوة والتوحّش أن يُزهق أرواح عشرات الآلاف في حروبه الداخلية بينما لم يُزهق قطرة دم واحدة في حرب مع عدو منصوص على عداوته في كتابات المفكرين اللبنانيين بكلّهم، وفي الدستور الذي يفترض أنّه عهد بين اللبنانيين، أي العدو الإسرائيلي، ما يؤكد أننا في أزمة ثقافة سياسية في لبنان.
الدولة يعني عندما ننقل «جماعتنا» إلى القضية لا أن نأتي بلبنان إلى طائفتنا وحزبنا وفئتنا. المفارقة أن قلّة من مكوناتنا انتقلت إلى الفضاء العام، قلة ربطت بين ذاتها وبين القضية، انتقلنا بالتحديث إلى دولة المؤسسات وبقينا بالثقافة قبائل تتحدث لغات أجنبية.
وانحسر تفكير بعضنا بتقاسم السلطة والنزوع للسلطة حتّى لو بكلفة حروب أهلية، وبعضنا لا عيش له إلا بخطاب مهاجمة الآخر وبيع الخارج سندات مواقفه ضدّ شريكه في الوطن، ما يؤكّد أننا نعاني من أزمة معرفية وثقافية وأخلاقية قبل أن نتحدّث عن أزمة مؤسسات.
الأوطان تحتاج إلى تحديد الذات بالذات وليس بالآخر، وتحتاج إلى تحديد التمايز عن الآخر، وتحتاج إلى تحديد العدو ومواجهته. من دون هذه الشروط لا تنبني هوية جماعية ولا أوطان ناهيك بدول. لذلك، فإن الإصلاح المعرفي وإعادة إحياء وتنشيط مفهوم الدولة الوطنية ومعناها هي الخطوة الأولى لبناء أمن وطني قبل أي حديث آخر.
كاتب لبناني